«المحمدية والعرق الزنجي» كيف اندمج الأفارقة مع تعاليم الإسلام؟

القاهرة: عبد الغني محمد دياب
في كتابه “Christianity, Islam and the negro race” قدم المفكر الإفريقي إدوارد بلايدن، صورة شاملة عن كيفية تفاعل الأفارقة على اختلاف لهجاتهم ومواقعهم الجغرافية مع تعاليم الدين الإسلامي، عاقدا مقارنة بين هذه الخالة وما حدث مع الديانة المسيحية التي دخلت إفريقيا عن طريق حملات التبشير الأوروبية.
ويقول بلايدن إنه حتى السنوات القليلة الماضية كان طلاب الأدب العام في أوروبا والولايات المتحدة، يعرفون مجرد أسماء فقط عن الشرقيين الأكثر إسهاما في الدين أو السياسية أو الآداب أو التعلم، وكانت رؤيتهم عن العالم الشرقي أنه بلا إنجازات علمية، وأنه لم يحقق منها إلا القليل جدًا، بل بعضهم ذهب إلى أن الشرق بعيد كل البعد عن العلم ومعارفه، لكن بفضل مقتضيات التجارة، والحماسة التي صاحبت الأعمال الخيرية، والترقي العلمي أصبح الشرق “أقرب إلى الظهور وبات معروفا بشكل أفضل ليس فقط في الحياة الخارجية، ولكن في بعض الجوانب التي تميز بها، مثل الدين، وأشكال الحكم والسياسية، والرؤية الشرقية عن الأجناس الغربية.
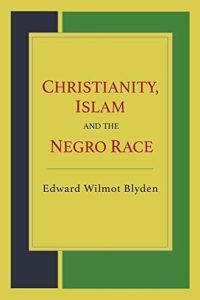
مؤخرا قد أعلنت سلطة مرموقة أن “الإلمام الدقيق باللغات والأفكار والتاريخ وآثار الأمم الشرقية ليست رفاهية طويلة، بل ضرورة، كما أن الزيارات التي تمت في غضون السنوات العشر الماضية، من الحكام الشرقيين إلى أوروبا مثل (سلطان تركيا، وخديوي مصر، وشاه فارس، وسيد زنجبار) تم استحضارها في الذهن الشعبي الحي للأوروبين، فيما يتعلق بطابع البلاد وحالتها وتأثيرها.
وتم الابتعاد عن المسار المطروق للآثار الرومانية واليونانية، والتي تعلى من اعتبارات في الغالب مادية، والتجول في تلك المسارات التي يتطرق لها سوى أولئك الرواد المتحمسين لدراسة حضارات الشرق مثل السير ويليام جونز.
يجد الطالب الغربي كثير من المكافآت النادرة والتي هي أغني كثيرا مما يتوقع في مثل هكذا دراسة، وحتى أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة للتعرف على اللغات الأجنبية بشكل كامل، يجدون ما يكفي في الترجمات، لإلهامهم في معرفتهم عن الموضوعات الشرقية، بل وحتى نقل هذه المعرفة لغيرهم، وإن كانت هذه الترجمات ليست كافية ولا مرضية في كثير من الأحيان.
إلى الطبقة الأخيرة ينتمي السيد ر. بوسورث سميث، مؤلف العمل المعروض علينا، والذي يبلغنا في البداية أن ” المؤهل الوحيد الذي يجعله يخاطر بوصف نفسه كاتب عن الإسلام هو عمله المستمر وقراءته الجيدة ودراسة الكتب الموجودة في اللغات الأوروبية عن الإسلام، والتي كتبت بواسطة المتعاطفين مع هذا الدين.
السيد بوسورث سميث الذي تخرج من إحدى الجامعات الإنجليزية، منذ اثني عشر عامًا فقط، وبالتالي لا يزال شاب نسبيا، يمكن اعتباره أحد أبرز النتائج على النشاط المتزايد في دراسة الأبحاث الشرقية، وهو يشرح لنا “علامات ظهور الحضارة الشرقية” وكأنه يقف على أكتاف “كوسان دي بيرسيفال، وسبرينجر وموير ودويتش” فهل يجوز له أن يدعى أنه أفضل منهم، وفي هذه الحالة سنقع في خطأ كبير إذ اعتبرنا أن كتابه مناسبًا ليكون نقطة بداية مهمة وطريق إلى رؤية أكثر تسامحًا – إن لم يكن متعاطفًا – عن دين العالم الشرقي.
أعمال الكتاب المذكورون للتو، وإن لم يكونوا مشهورين، إلا أنها تدلل على أنها كتبت من قبل علماء ولأجل العلماء مع الحفاظ على النظريات أو معارضتها في معظم الأحيان، وتحظي بأهمية أدبية أو تاريخية.
جلب السيد بوسورث سميث لعمله ليس فقط التقدير الشامل للأدب و الأسئلة التاريخية التي تنطوي عليها ولكن الاحترام الجاد “لمشاكل أعمق من النفس البشرية”، والاعتزاز بهذا الاقتناع السليم والمثمر، الذي يسعى إلى أن ينقل لقرائه، “أن المحمديين قد يتعلمون الكثير من المسيحيين، ومع ذلك يظلون محمديين؛ وأن المسيحيين لديهم شيء على الأقل ليتعلموه من محمد، الأمر الذي لن يقلل منهم بل سيجعلهم مسيحيين أكثر مما كانوا عليه من قبل.
يتابع السيد بوسورث سميث مناقشة هذا الموضوع المهم، والذي ركز عليه، ليس بصفته محبا للإسلام، ولكن بدرجة من الجدية، والفطنة، والكاثوليكية، وقوة التفكير التي تجعل عمله ليس فقط تعليميًا، ولكن مثيرًا للاهتمام أيضًا كمؤشر على نزعة واتجاه الفكر المثقف في إنجلترا. لقد دخل في روح الإسلام بطريقة مثيرة ولم تحدث في أعمال لين، سبرينجر، دويتش، وويل، ومن شأنها أن تثير الدهشة في عالم غربي بالنسبة له كرجل إنجليزي
محاضرة العميد ستانلى حول هذا الموضوع أيضا حظيت بكثير من الاهتمام، وإن كانت مجزأة و محدودة بالضرورة في مداها من قبل طبيعة نطاق العمل، على الرغم من اتساع نطاق الرؤية، والحياد السخي، وعبقرية الروح التي تميز بها بشرف السيد بوسورث سميث من بين جميع كتابات العلمانية والمسيحية الإلهية، ليس فقط من أجل التحقيق الكامل والعادل والحر في الإجراء العملي لملامح الإسلام ، ولكن من إصدار حكم واضح وغير متحيز لا لبس فيه، وتأثير ذلك سواء تم الاعتراف به أم لا يجب أن يحدث في جميع أنحاء العالم الأدبي.
لكن أعمال كأعمال “لويس ماراكسي، وبريدو ووايتير فيما بعد” تكاد تكون مستحيلة في الجدال الديني، ففي جميع المؤلفات لا يوجد رجل مثقف، مهما كان استقصاء وتحققه بعيدا عن انحيازاته الخاصة، ومهما حاول في المستقبل أن ألا يظهر ذلك سيحاول إخضاع أي نظام ديني للمحنة البروكروستانية.
وبقدر ما يتعلق الأمر بالإسلام، فإن العلماء ينشأون في صفوفه مشبعين بالتعلم الغربي، ويأخذون دورًا ليس فقط في الدفاع عن عقيدتهم، ولكنهم من المترجمين الفوريين بين العالم الشرقي والغربي. وسبب ذلك بعض من المفاجأة مؤخرا، وعلق كثيرون عليه.
يجب أن يكتب كاتب محمدي عملاً مقتدرًا باللغة الإنجليزية، “يتحدى به مقالات المفكرين الأوروبيين والمسيحيين” على غرار مقالات سيد أحمد عن أرض الإخلاص.
وظهر عمل آخر باللغة الإنجليزية كتبه شاب محمديا، ناقش فيه بإيجاز واعتدال واقتدار الموضوعات المختلفة التي يهاجمها الإسلاميون عادة. ولكن ليس فقط في الأيام الأخيرة، كما قد يشير الكاتب في المجلة الفصلية البريطانية، و”على ما يبدو أن المحمديين قد فشلوا في الدفاع عن إيمانهم بالقلم” رغم أن هناك دائمًا جدل دائر بخصوص هذه النقطة، وهو قائم الآن، لكن لم يحز على شهرة كبيرة في الغرب كما حصل مع عمل د. بفاندر، والذي يهاجم فيه النظام المحمدي، وورد عليه العالم المسلم رحمة الله بذكاء وحاسم، في كتاب ميزان الحق باللغة العربية، وحقق فيه نتائج رائعة.

لكن بالنسبة للتقارب مع الأدب الأوروبي، لم نسمع عن أي محاولة للرد على عمل رحمة الله، ونسخة هذا من هذا الكتاب باللغة بين يدي أحد المحمديين من غرب إفريقيا في سيراليون، والذي كان يقرأها ويعلق عليها لعدد من أتباعه في الدين.
يسعدني أن ألاحظ أن كتاب السيد بوسورث سميث قد أعيد نشره في الولايات المتحدة، وأن مقالة دوتش في
الإسلام أعيد نسخه في نفس المجلد في الملحق، وهو ما يحقق المساواة. وهو يغني عن السفر لزيارة الدول المحمدية/ الإسلامية، كونه يتأمل في عالم اللاهوت الخاص بها، ويقدم رؤية واضحة للنظام الديني الذي يشكل مصير الملايين من الناس، لأننا بتنا نحمل في جيوبنا الآن مجموعة كاملة من الأدب المحمدي.
إذا كنا باستثناء المادة رائعة جدا على فيمكن الرجوع إلى “البيانات التاريخية في القرآن”، والتي كتبت عام 1832 من قبل المراجع ، ، السيد ج. أديسون الكسندر، و”استعراض القرآن” للبروفيسور دريبر من جامعة نيويورك، في كتابه تاريخ التنمية الفكرية في أوروبا، لكن المنح الدراسية الأمريكية لم تنتج شيئًا مهمًا في هذا الفرع الأدبي حتى الآن.
الجزء الشيق الموجود أمامنا الآن، والذي نقترح أن نلاحظه بشكل خاص، هو ذلك الجزء من المحاضرة الأولى التي تشير لطابع وتأثير الإسلام في غرب ووسط أفريقيا. يقول دين ستانلي: – “لا يمكن أن ننسى أن المحمدية هي الدين الأعلى الوحيد الذي أحرز حتى الآن تقدما في قارة إفريقيا الشاسعة.
على أية حال قد تكون ثروات المستقبل للمسيحية الأفريقية، لا يمكن أن يكون هناك شك في أنها ستتأثر لفترة طويلة بعلاقاتها مع الأكثر تعصبا والجزء الأكثر تبشيرا في عالم مسلم من المتحولين الزنوج”.
وإذا كان هذا الرأي صحيحا، فلا يمكن أن يكون العالم المسيحي غير مبال بمناقشة موضوع مليء بالأهمية خصوصا وأنه يؤثر على مصالح الكنيسة ولو في فرع واحد المتعلق بالمصالح الخيرية والتي تهتم بها الكنيسة حاليا أكثر من أي وقت مضى.
توغلت تيارات النفوذ الإسلامية إلى إفريقيا عبر ثلاث تيارات رئيسية، واحد من مصر عبر بلاد النوبة، ومنها إلى بورنو والهوسا، وآخر من الحبشة إلى اليوروبا والأشانتي (شعوب غرب أفريقيا) والثالث جاء من الدول البربرية عبر الصحراء الكبرى ومنها إلى تمبكتو.
أول بعثتين من هذه البعثات والخاصة بمصر والجزيرة العربية كانتا يقومان بالتبادل التجاري للمواد الخام مع السودان وما حوله من المدن، بينما الثالث جاء إلى غرب أفريقيا عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، من خلال الصحراء الكبرى، واتخذ تمبكتو كمركز للتجارة، ومن بعده أصبحت المدينة منفذ لثروة نيجيريا. حتى في أيام هيرودوت يبدو أنه كان هناك إجماع على أن تكون منطقة تشاد والبحر الأبيض المتوسط، لتجميع المنتجات القيمة التي تم جمعها من مراكز مختلفة عبر حركة المرور الواسعة والتي لا تزال تزدهر
في الداخل فقط، لكن تم تقاسمها مع العديد من القوافل التجارية التي وجدت طريقها للرواج عن طريق السفن الفينيقية ومنها إلى بلدان مختلفة من أوروبا والشام.
وطوال الوقت لم تنقطع منطقة وسط إفريقيا تجارياً عن المجرى الأوروبي والآسيوي، وظل التواصل قائما مع هذه المناطق حتى القرن التاسع عشر، حينما بدأ المسيحيون التعريف بالله الحقيقي و تغلغلوا في مناطق نيغرو لاند (غرب أفريقيا). قبلها كان الإسلام حاضرا منذ أن نجح عقبة ذلك الجنرال المسلم المرموق، في إخضاع شمال إفريقيا للإسلام ، والذي سار من دمشق على رأس جيش من الأتباع المتحمسين ، وفي أقصر فترة ممكنة انتشرت انتصاراته على طول سواحل شمال إفريقيا، متقدمًا إلى حافة المحيط الأطلسي والتي كانت عوارضه نهاية تقدمه نحو الغرب، لكن الإسلام الذي لم يستطع التقدم غربا، اتجه شمالا وجنوبا، وواصل تقدمه في الجنوب متغلغلا في الصحراء المهجورة متخطيا السودان، ونجح في إقامة مركزًا لنفوذًه في تمبكتو في أقل من قرن واحد من الزمن.
ومنذ ذلك الحين استسلمت القبائل النيجيرية الكبيرة لتأثير الإسلام؛ وشكلت بسرعة من تعاليمه الأفكار والأخلاق والتاريخ ، حدث ذلك منذ العصور الوسطى، وذكرها الرحالة العربي ابن بطوطة، الذي زار تلك المناطق، واكتشف أن الإسلام قد اتخذ جذوره الراسخة بين الشعوب القوية في هذه المنطقة، وبات الدين الجديد هو محور العادات والتقاليد في المنطقة، بل وسيطرة أفكاره على الحياة الاجتماعية والدينية للسكان. ومن بين الصفات الجديرة بالثناء التي لفتت انتباه ابن بطوطة كنتيجة للتحول الكبير الذي طرأ على المنطقة مع دخول الإسلام،هو إخلاص السكان الكبير لدراسة القرآن.
ومن ذلك ما نقلته النسخة الفرنسية لبعض الحوادث التوضيحية والتي يقول فيها: ” لديهم حماس كبير لحفظ القرآن الكريم، الأصفاد على أقدامهم ولا تنزعها إلا إذا عرفوا كيف يقرأونه من الذاكرة، حتى في يوم العيد دخل بيت القاضي ورأى أولاده كذلك”.
قلت له: “ألن تطلق سراحهم؟”
قال: لن أفعل ذلك إلا إذا عرفوا القرآن عن ظهر قلب.
ومرة أخرى مررت أمام زنجي شاب، وسيم الوجه ، ويرتدي ثيابًا رائعة، ويرتدي سلسلة ثقيلة على قدميه. قلت للشخص الذي رافقني: وماذا فعل هذا الولد؟ هل قتل أحدا؟ سمع الشاب الصغير كلامي وضحك. وقال لي: “لقد كان مقيد بالسلاسل فقط لإجباره على تعلم ترديد القرآن من الذاكرة”.
المحمدية الأفريقية تضم في صفوفها القبائل الأكثر طاقة وحيوية، كما أن أتباعها يتمتعون بالكياسة وهم الوحيدون الذين شكلوا حكم مدني قائم على رابطة التنظيم الاجتماعي، كما أنها هي من قامت ببناء واحتلال أكبر المدن في قلب القارة، وقوانينها هي المنظمة لأقوى الممالك في القارة (فتاح، مسينة، الهوسا، برنو، واداي، دارفور ، كردفان، سنار) ليس هذا فحسب بل إن المحمدية أنتجت وتحكمت فيما هو أهم من ذلك وهو التجارة بين أفريقيا والدول الأجنبية؛ إنها تكتسب يوميًا من يغيرون دينهم من جموع الوثنية؛ وهي تفرض الاحترام بين الجميع الأفارقة، وأينما عمل المحمدون لم يخضع الناس لطريقة القرآن بالقوة.
لا أحد يستطيع السفر لأي مسافات في المناطق الداخلية من غرب إفريقيا دون أن يصطدم بالجوانب المختلفة للمجتمع في هذه المناطق، ورغم تنوع السكان بين مسلم ووثني، يمكن رصد هذه الاختلافات بسهولة سواء في اختلاف أساليب الحكم، أو غيرها من العادات، وبشكل عام لوائح المجتمع وتقاليده وحتى أدوات التسلية مختلفة، فالعروض الفلكوروية الصاخبة يمكن ملاحظتها في الجنب الوثني وتختفي كما أصبح الناس تحت تأثير المحمدية.
وليس من الصحيح أنه “عندما تغرب الشمس، كل أفريقيا تقضي وقتها في أداء الرقصات التقليدية، لكن الحقيقة أنه عندما تختفي الشمس يظهر تأثير الإسلام على الناس، فأولئك الذين كانت حياتهم مليئة بالمتعة والإثارة الآن لديهم خمسة أوقات في اليوم يذهبون فيها إلى المسجد، حيث يقضون ربع ساعة في كل مناسبة في التمارين التعبدية، ويتجمعون في مجموعات بالقرب من المسجد لسماع القرآن الكريم ، أو التقاليد أو قراءة الأحاديث أو بعض الكتب الأخرى.
في العبور من المنطقة الواقعة بين سيراليون وفوتا جالون في عام 1873، مررنا بمدن باغان المكتظة بالسكان؛ و بالتجول في هذه المدن توجد أحياء محمدية ملفتة للنظر، وعندما تدخل إلى منطقة وثينة ثم تدخل لمجتمع مسلم تلاحظ أنك دخلت في جو أخلاقي منفصل على نطاق واسع، وأعلى من ذلك الذي تركناه في المناطق الوثنية، واكتشفنا أن شخصية ومشاعر وظروف الناس تغيرت للأحسن بشكل عميق.
ومن الواضح أن كل ما يمكن أن يقال عن القرآن، أنه كان سببا في تغيير حياة القبائل الإفريقية التي آمنت به، وأن هذا التقدم لم يكن على المستوى العقائدي فقط ولكن في جميع نواحي الحياة، وكلما تمسكت هذه المجموعات بالقرآن كلما تجاوزت حالتها البدائية.
القرآن في مقياسه معلم مهم، يتجلى تأثيره بوضوح بين الناس البدائيين بشكل رائع، ويقدم مجموعة هائلة من التعاليم لأتباعه وخصوصا على مستوى الوحدة بين قبائل (Hausas، Foulahs، Mandin-go Soosoos ) فالقرآن ساهم بشكل كبير في تقدمهم، فكل هؤلاء يمكنهم قراءة نفس الكتب والعبادة معًا، كما أنهم يخضعون لسلطة واحدة مشتركة وحكم واحد نهائي، خصوصا أنهم متحدون من خلال المشاعر الدينية الشائعة، ومن خلال العداء المألوف للوثنية.
ليس هذا فقط بل حتى التعابير اللغوية مشتركة، وتحظى كلمات الكتاب المقدس بأكبر قدر من الاحترام والتقدير. وحتى في حالة عدم فهم الأفكار تمامًا، يبدو أن الكلمات تمتلكها جمال وموسيقى مجهول الهوية، عبر مضمار غير واضح ومجهول التحديد، غير مفهوم لأولئك الذين يتعرفون على اللغات الأوروبية فقط. إنه من السهل على غير المطلعين باللغة التي كُتب بها القرآن، وبالتالي الحكم عليهم كغرباء، أن ينغمسوا في ذلك.
والحقيقة أن من ينتقدون إيمان الأفارقة بالقرآن يفقدون حقيقة أن القرآن هو تركيب شعري لغوي جذاب، يعبر عن الحالة الأكثر التصاقا بمعناه، وبالتالي فإن الأمر لا يقتصر على مجرد كلمات بلغة مختلفة، لكن الأفكار واللغة التي نقلها القرآن لا يمكن فصلها عن الأفكار الواردة به، والشاعر الحقيقي لا يخلق التصور فقط، بل الكلمة التي هي مركبة، من عدد من المقاطع التي لا يمكن فصلها عن الفكر. بمعني آخر هذا القرآن بشاعريته وحالته التي يخلقها لا يمكن ترجمته بشكل كامل، ويمكن رصد هذا في النسخ العديدة التي تمت دراستها في كل عصر للوصول إلى المعنى الشعري.
ففي أجزاء من الكتاب المقدس. لا توجد كلمات مؤثثة حتى الآن من قبل الأدب اليوناني أو الروماني أو التوتوني يمكن أن تكون ملائمة تمامًا لإبراز الجمال الخفي في الأصل السامي للكلام المقدس، لذلك لا يُنصح بين المسلمين بقراءة الترجمات المكتوبة أو المطبوعة للقرآن. الصينيون، الهندوس، الفرس، الأتراك، والماندينغو وغيرهم من الشعوب التي اعتنقت الإسلام يتحدثون بألسنتهم التي ولدوا فيها، ولكنهم يقرؤون القرآن بالعربية.

وكان السيد بوسورث سميث محقا في بدء استعداداته للعمل القيم الذي كتبه من خلال دراسة متأنية للقرآن، ولكنه كان منتبها لهذه النقطة لذا أعرب عن أسفه لأنه لم يتمكن من الوصول إلى جمال النص الأصلي، والذي لم يتمكن من الوصول إلى قيمته أحد مما بذلوا جهد في هذا الشأن مثل “كاسيميرسكي، لين، ورودويل” كلهم قدموا ترجمات ممتازة، لكن لم تكن بعظمة النص الأصلي.
لذلك على المهتمين بهذا الأمر من رجال البحث أن يخضعوا تلك الظاهرة للدراسة، بل من الضروري دراسة الأمر بعناية لما يحمله هذا الأمر من أهمية، ومن المستحسن أن يتم فحصه من جميع وجهات النظر، لأنه لا يمكن بأي وسيلة أخرى أن نأمل في الحصول على نظرة ثاقبة واضحة عن أصل الإسلام، إلا من خلال دراسة متأنية للكتاب الذي يحتوي على مبادئه الأساسية.
وبالنسبة للعالم الخارجي، الذي يتأثر بسهولة بالانطباعات السطحية، وينتقل بعيدًا عن مجرد اهتمامات درامية، قد لا يكون هناك شيء جذاب في تقدم الإسلام بأفريقيا، لأنه الأمر يشبه معرفة الفرس بالقراءات الغربية، كذلك الأمر بالنسبة لتاريخ المحمدية في أفريقيا. لذا يجب أن نتعرف على الشخصيات العظيمة والحلقات المهمة المفقودة، عبر رؤية تنقلها عقول حكيمة ومتطورة، عن هذا التحرك الجماهيري الكبير.
وطوال هذه المدة لم يكتب أي شاعر أو مترجم القرآن باللغات غير العربية، بل كان لديهم عدد قليل جدًا من القراء في البلدان المسيحية، ممن هم على دراية بالداخل الإفريقي جاءوا من العالم المحمدي في شمال إفريقيا والجزيرة العربية- ومن المعروف جيدًا أن العديد من هذه الشخصيات قد عاشوا في إفريقيا، كما أن الزنوج المسلمون، كان لهم تأثير ولو ضئيلًا في الشؤون العسكرية والسياسية للإسلام، ليس فقط في إفريقيا، ولكن في أراضي معلميهم من المحمدين، نجد ذلك في السير الذاتية لابن خلكان (عالم مسلم من دمشق) حيث يشير إلى بشكل متكرر إلى المسلمين الزنوج المتميزين. بعض هذه الأعمال يمكن أن رصده في الدور الذي لعبه بعض هذه القيادات الذين وظفوا حماسهم وشجاعتهم لنشر الإسلام في أجزاء كبيرة من نيجيريا.
كان من أبرز هذه الشخصيات التي أثرت في تاريخ المنطقة الواقعة بين تمبكتو والساحل الغربي، وهو من مواليد فتاح تورو، وكان معروفا باسم الشيخ عمر الحاج. ويُقال إنه كان رجل له أوقاف غير عادية، وصاحب حضور مهيمن وتأثير شخصي كبير. تلقى تعليمه على يد الشيخ التيجاني، وهو شيخ مسلم من الجزيرة العربية.
وبعد أن قضى الحاج عمر عدة سنوات تحت إشراف هذا المعلم المتميز، الذي قام بزيارة مدينة مكين، وفي الوقت نفسه، أصبح متعلمًا بعمق في اللغة العربية، بعد وفاة سيده ذهب مرتين إلى مكة للحج. وعند عودته إلى بلده للمرة الثانية، نفذ سلسلة من الحملات الدعوية بين القبائل الوثنية القوية الموجودة في جنوب شرق فوتاه تورو (منطقة بالسنغال(.
والأمر نفسه حدث في سيجو (منطقة في مالي) حيث قصدها العديد من الرؤساء الأقوياء ونشروا فيها الإسلام، ومن خلالهم انتهت المظاهر الوثنية وارتفعت ممارسات المحمدية، وكذلك المقاطعات التي كانت مليئة بالمفاهيم الوثنية، تم نشر الإسلام فيها، عن طريق قائدين يدعا هيثوس جين، وحمد الله وكان الأخير هو حاكم سيجو، وحدث ذلك بعد عشر سنوات من دخول سيجو، بمساعدة عرب تلك المنطقة، وأحيط بهم وقتل في هذه الوقائع أحد أبناء حمد الله، لكنه نجح في السيطرة على مدينتين من أكبر مدن غرب أفريقيا.
كتب الحاج عمر العديد من الأعمال الأدبية والشعرية، وقصائده تتلى وتغني في كل بلدة وقرية محمدية، من بلدة- فصله ، في سيراليون ، إلى كانو، وتحظى ذكراه باحترام كبير من قبل جميع الطلاب، وينسبون إليه الكثير الأعمال الخارقة، وانظر مثلا إلى مشاريعه الناجحة، الأدبية والعسكرية، كلها تمثل براهين الهداية الإلهية التي تمتع بها هذا الرجل.
لقد سمعنا عن أمثلة عديدة لهؤلاء العباقرة “نصف العسكريين ونصف المتدينين”، كما يسميهم بوسورث سميث، وكذلك عن طريقتهم الإسلامية التي تبدو قادرة على الإنتاج “.
من هذا الاستعراض السابق إلى مسلمي المدن الزنجية الأخرى، وبعيدًا عن الحضارة المعقدة للحياة الأوروبية، بمصالحها المتنوعة، فإن تصوُّر الإسلام هو الشيء العظيم الوحيد الذي يجب أن يشغِّل الاهتمام بالكائن القومي. إنه صراع بين النور والظلام، بين العلم والجهل، بين الخير والشر، فإن الحماسة التقليدية تجعل إيمانهم غير مبالٍ بالآخرين.
معاناة كل من يقف في طريق نشر الحقيقة كانت كبيرة، لأن المسلم يصبر على أي شرور ويتحملها من أجل ضمان ذلك، ومن أشهر الشعارات التي قيلت في هذا الأمر وضمنت انتصار المنطقة. “الجنة تحت ظلال السيوف”.
وهناك فقرة واحدة في كتاب السيد بوسورث سميث،، والذي لا نعتقد أن مؤلفه ذهب إلى أفريقيا، والتي أدركت أنها المصدر الكامل لهذه الرؤية، ولكن العالم المسيحي، كما يبدو لنا ، سيحسن الحظ أن نتأمله. وهي كالاتي: “لاحظ الرحالة المسيحيون، مع كل رغبتهم في التفكير بطريقة أخرى، أن الزنجي الذي يقبل المحمدية يكتسب في الحال إحساسًا بكرامة الطبيعة البشرية، وهو شعور ليس شائعا حتى بين أولئك الذين جُلبوا لقبول المسيحية”.
بعد أن تمتعت بمزايا استثنائية للمراقبة والمقارنة في الولايات المتحدة، وجزر الهند الغربية، وأمريكا الجنوبية، ومصر، وسوريا، وغرب ووسط إفريقيا، اضطرت ولكن على مضض إلى تأييد البيان الذي أدلى به السيد. ب. سميث. ونحن لا نتفاجأ في استحوذه على هذه الحقيقة الأكثر أهمية في أبحاثه وإعطاء الأهمية القصوى لها – وهو ما يستحقه بغزارة – في المناقشة. أينما وجد الزنجي في الأراضي المسيحية، فإن صفته الرئيسية ليست الانقياد، كما يُزعم الكثيرون، ولكن الخدمة. إنه بطيء غير تقدمي.
قد يصادف الأفراد هناك ذكاء غير عادي، ومغامرة، وطاقة ، لكن لا توجد جماعة مسيحي زنجي في أي مكان يعتمد على نفسه ومستقل بشكل كامل، في هايتي وليبيريا، أو ما يسمى بجمهوريات الزنوج، يكافحون فقط من أجل الوجود، ويتمسكون بتسامح القوى المتحضرة.
إفريقيا المسلمة كانت تعتمد على نفسها، ومنتجة ومستقلة، ومهيمنة، دون موافقة أو رعاية من دول الأصل، حتى الدولة العربية التي اشتقوا منها مؤسساتهم السياسية والأدبية والدينية لم يكن لها أي دور في حياة هذه الدول، في سيراليون كان المسلمون يعيشون دون أي مساعدة من أي حكومة – إمبراطورية أو محلية – أو أي مساهمات من مكة أو القسطنطينية، أقاموا مساجدهم وحافظوا على ديانتهم، ونظموا الخدمات و أداروا مدارسهم بكل حرية، وساهموا في دعم المبشرين الذين جاءوا من الجزيرة العربية أو المغرب عند زيارتهم للمنطقة.
نفس الشيء بالنسبة للمسيحيين لا يمكن الدفع عن المسيحية مجاملة للمسيحيين الزنوج في هذه التسوية، لأن المسيحيون الأصليون الأكثر استنارة يتطلعون إلى بجدية إلى الوقت الذي سيتم فيه حجب التعليمات والتأثير من لندن.
وفي هذا الصدد تحتوي ورقة بحثية جيدة عن “حالة ورغبات ليبيريا”، بقلم ليبيري ذكي وصريح ، على ما يلي: نفتقد كشعب لروح التحرر. لقد تعلمنا الاعتماد على المؤسسات الأجنبية لدعم كنائسنا. هذا لا ينبغي أن يستمر كذلك. في الواقع، ليس لدينا ما يكفي من الدين المسيحي لحثنا على المساهمة! بإخلاص لقضية الإنجيل؛ وإذا كان لدينا ما يكفي من الحماس، لكان المسيح يجعلنا مستعدين للتضحية بالوقت والمال من أجل الخير، لكنا نتخلى أيضًا عن الكنائس والدين، لقد عرفت بعض شمن الأشخاص الذين يغيرون توجهات فقط من أجل الحصول على سنت أو سنتين من الكنيسة. نأسف لمثل هذا الدين! واحسرتاه بالنسبة للكنائس التي دعمت هكذا، في حرب أشانتي الأخيرة، كانت القوات الزنوجية الأكثر جدارة بالثقة هي الهوساس، وهم محمديون محافظون، وفي حروب الهند الغربية لم يتم الاعتماد على القوات الزنوجية أيضا.
الآن، ما الذي أحدث هذا الاختلاف في تأثيرات نظامين على العرق الزنجي؟
يجب أن يُعزى الاختلاف إلى الاختلاف في الظروف التي بموجبها يؤثر النظام على أولئك الزنوج الذين اعتنقوا ذلك أو تلك، لكن وجدت المحمديون الزنوج يتمتعون بكامل الحرية والاستقلال في بلدهم، تمتعوا بكامل الاستقلال حتى عن معلميهم الذين نقلوا إليهم الإسلام، وعندما عرض عليهم الدين كان لهم حرية الاختيار لأنفسهم. يذهب المبشرون العرب الذين التقينا بهم في الداخل إلى عدم استخدام “المحافظ أو الأسهم” بل نشروا دينهم عن طريق تعليم القرآن بهدوء.
لقد اتحد المبشرون الأصليون من رجال “الدينجا والفولا” (قبائل إفريقية) لنشر إيمانهم وتفعليه، وأينما ذهبوا فإنهم ينتابهم الانطباع بأنهم ليسوا وعاظًا فقط، لكنهم تجار جيدون، وفي كثير من الأحوال فهم ليسوا مجرد تجار، بل خطباء وبهذه الطريقة وبشكل يبدو صامتا وخفيا تحول الناس من حولهم إلى تلاميذ مطيعون يروجون بحماس للإسلام، ويدخل في هذه الدائرة بصفة عامة المتحولون إلى الإسلام، لأنهم يسلمون بكامل اختيارهم وقناعتهم، لذلك كانوا يعملون بكل رجولة وحيوية لدعم عقيدتهم الجديدة.
عندما تم عرض الدين لأول مرة على الناس في هذه المنطقة وجدوا أنفسهم يمتلكون جميع العناصر ويتمتعون بكل الامتيازات ووجدوا تعاليمه لا تقيد حرياتهم ولا تسلبهم أي شي، بل تمنحهم قوة إضافية وتجعلهم مؤثرين في العالم من حولهم، لأن تعاليم الدين الجديدن تطالبهم أن يكونوا مرشدين ومدربين لجيرانهم الأقل معرفة بالإسلام، كما أنها جلبت التفوق ومنحتهم احترام الذات الذي يحتاج لأن يشعر به الرجال في هذه المناطق.
لقد كان شيئًا جديدًا تمامًا، وألهمهم بمشاعر روحية كانوا من قبل غرباء تمامًا عنها، بالإضافة إلى بث روح الاستقلالية والاعتماد على الذات والتي بدأ استغلالها بالفعل، ولم يتم تدمير مؤسساتهم المحلية التي كانت موجودة قبل دخول النفوذ العربي. لقد اتخذوا أشكالًا جديدة فقط، وقاموا بتكييف أنفسهم مع التعاليم الجديدة للإسلام.
في المجتمعات الموجودة في غرب ووسط أفريقيا يمكن ملاحظة أن البنية الفوقية العربية لم يتم فرضها على السكان الأصليين ولم يكن هم دائما يمثلون البنية التحتية، بل ما حدث أنه عندما التقى العربي بالزنجي في منزله اندماجًا اندماجا صحيًا، ولم يحدث أي امتصاص لأي العنصرين.
لقد كان المنظور الشرقي للإسلام مختلفا إلى حد كبير في نيغرور لاند، ولم يكن بالشكل العام المفترض حاليا، فمثلا لم تحدث تسوية مهينة للخرافات الوثنية بالمنطقة، بل تم الأمر من خلال الإبقاء على العديد من عادات وتقاليد المنطقة التي تتناسب مع الدين الجديد، والتي أكثر اعتدالا وتصالحا بالنسبة للزنجي، فقابل تمبكتو طالما احتفظت بعاداتها وتقاليدها، لجانب بعض التقاليد المستمدة من الدين الجديد واليت أضيفت على الأشكال التقليدية، فقد احتفظ الإسلام بتقاليد الزنوج بجانب تقاليده العربية الصارمة.
والأكثر تعقيدا أنه تم نقل النشاط الأدبي والتأثير الديني إلى هذه المنطقة، وخصوصا من كوكا بوهران، فمنذ أن أصبحت المنطقة مركزًا تجاريًا، نشأت عدد من المدن الزنجية في ظل النفوذ الإسلامي- وقد ترسخ الدين المخلص بين المجتمعات الأصلية الكبيرة العدد بالقرب من مصدر المياه كما الحال في النيجر، فقد الحركة المحمدية إلى حد كبير بالتأثيرات الجغرافية والعرقية التي تعرضت لها، كما أن غياب الضغط السياسي سمح للخصوصيات الأصلية والعادات التقليدية أن تعبر عن نفسها، وأن تقوم بدور فعال في عملية استيعاب العناصر الجديدة.
من ناحية أخرى فإن المسيحية انتقلت إلى الزنوج بشكل فوقي، جاءتهم مع العنصر الأجنبي الذي توسع في أراضيهم، وكانت التعاليم المسيحية تتوسع مع التوسعات التي تتم على الأرض، ووجد المواطن الزنجي نفسه وأطفاله يتلقون دروسًا دينية وتعاليم تكرس الدونية المطلقة، وتجعلهم دوما خاضعين الذين وقفوا أمامهم في تنظيم علاقاتهم الاجتماعية وتقاليدهم.

انتزعتهم المسيحية من البربرية وأجبرتهم على اعتناق المعتقدات الجديدة، وقدمت إليهم الديانة كأن يسوع احتضنهم، وكان هو مصدر وحيد للعزاء في كوارثهم العميقة، وسلسلة المعاناة والكرب الشديد الذي لا يتوقف، تم الاستيلاء عليها على أنها بلد واعد ، حيث ، بعد الأحزان غير المسبوقة لهذه الحياة، جاءت لتهدى من معاناتهم، وهزت قلوبهم، ووجهتهم بلا هوادة ليتعاطفوا مع مع “رجل الآلام المطلع على الحزن.”
وجهت المسيحية الزنوج المنبوذين إلى أحد أهم تطلعاتهم المتمثلة في المواطنة السماوية والأبدية، لذلك صاغوها في الأغاني والأخبار التي نقلوها بأفواههم – تلك الألحان ليست موجودة في أي مكان في العالم – والتي نقلت على ألسنة العبيد المتحررين إلى أوروبا، ومن خلالها سحروا وأسروا قلوب العائلات المالكة والنبلاء، بهذا الحنان والحب. أو ما يسميه خطيب لندن السامي “الجدية والصلابة المولودة من الشدائد في بيت العبودية: ” الزنجي هو حقا موسيقي أكثر من الإنجليزي. . . . غالبًا ما يغني بمرح والدموع مبللة على خده المصنوع من خشب الأبنوس، دون تسجيل لفرحه أو حزنه، ودون أن يرافقه صرخة من اللحن، أو عويل حزن متناغم، إذا تمكنا من تجريد أنفسنا من التحيز، فإن الأغاني التي تطفو في نهر أوهايو هي واحدة من حيث الإحساس والطابع مع أغاني الأسرى العبريين بالقرب من مياه بابل. نجد فيها نفس قصة الفجيعة والانفصال، نفس الحزن الذي لا يمكن إصلاحه، نفس الحنان الجامح والحلاوة العاطفية، مثل الموسيقى في الليل.
مع أن هذه مزايا كبيرة وثمينة؛ لكن بسبب الضغوط الجسدية والعقلية والاجتماعية التي تعرض لها الأفارقة، تأثرت المسيحية بشكل كبير، وكان تطورها بالضرورة متحيزًا وأحادي الجانب ومكتظًا وغير طبيعي، كانت الميول الفردية المستقلة مكبوتة ومدمرة، ولم يتمكن الأفارقة من التعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم إلا بما يتفق مع وجهات النظر وأذواق أولئك الذين حكموهم. لقد تم إقفال كل سبل التحسين الفكري لهم، وكان محكوما عليها بأن يكون جهلاء دائما.
في المقابل ربطت المحمدية الزنجي بالتعليم المعاصر، فمجرد ما كان يدخل في الدين الجديد كان يتم تعليمه القراءة، وقد ارتبطت أهمية التعليم بمعرفة الله ورسوله وكان ذلك مرتبطا بالعلم المعاصر، بينما ارتبط المسيحي الزجي بأوامر التحريم العقلي والمادي ولم يكن التعليم المسيحي مرتبط بالوقت المعاصر.
في السابق أتاح المحمدين للزنجي أن يختار بين القرآن وبين العلوم الأخرى، وكان مسموح له أن يمارس كل ما هو حق للمسلمين الآخرين ولكن لا يوجد قدر من الولاء لدى الزنجي للأناجيل، وكان عليه أن يسلم بكل ما تقوله الكنيسة، رغم أن ذلك لم يغير واقعه السياسي بل أخذها كوصفة طبية خضع لها في جميع بلدان منفاه.
في أي مكان يهبط فيه المسيحي الزنجي يلعب فيه دور العبد أو القرد أو الدمية، فقط عدد قليل نجا من هذا التدهور العام، وتحولت هذه الحالة الأخيرة هدفا لكثير من الإخوة غير المقتدرين.
العجيب إذن أن “الرحالة المسيحيين” تصدو لكل رغبة في التفكير بهذه الطريقة وحاولوا التعليق على الفوارق بين المسيحي الزنجي والمسلم، لكن الحقيقة أنه يجب القيام بذلك لأنه يمكن العثور على سبب آخر للتفوق الزنجي المسلم على المسيحي، أو يمكن أن نجد سبب آخر للرجولة الفائقة والأسلوب اللطيف للزنجي المسلم والذي هو على عكس المسيحيين تماما، هل لأنه وقعوا تحت التأثير المحبط للفن الآري.
الأمر الثاني يمكن أن نفهمه بشكل واضح في رؤية الأديان للرسم والفنون، فمثلا المسلم يتفق مع اليهود، في تحريم كل تمثيل للخلائق الحية من كل الأنواع؛ ليس فقط في الأماكن المقدسة ولكن في كل مكان.
ويخبرنا يوسيفوس (مؤرخ يهودي) أن اليهود لن يتسامحوا حتى مع عمر الإمبراطور الذي تم تمثيله على نسور الجنود، ويعتقد الآباء المسيحيون الأوائل أن الرسم والنحت محظوران من قبل الكتاب المقدس، وأنهم هم من الفنون الشريرة.
بينما المحمديون في نيغرو لاند يرفضون وجود حتى أدق التمثيل لأي كائن حي على الأرض أو على جانب المنزل، ولن ننسى أبدًا الاشمئزاز من الماندينغو كانكان، الذي كان مجسدا في اللوحة البحرية في مونروفيا.
لا يمكن لأحد أن ينكر المزايا الجمالية والأخلاقية العظيمة التي أصابت العرق القوقازي من الفن المسيحي، عبر جميع مراحلها. من التطور الذي ظهر في شكل الراعي الصالح، لسراديب الموتى إلى تجلي رافائيل، من خلال الفسيفساء إلى الرقة التي لا توصف وجمال جيوتو وفرا أنجيليكو. ولكن بالنسبة إلى الزنجي أظهرت كل هذه العروض والتماثيل فقط الخصائص الفيزيائية للجنس الزنجي، وبينما كانوا يميلون إلى تسريع الأذواق وإعادة صقل الأحاسيس في هذا العرق، لم يكن لدي الزنجي سوى حالة الكآبة والإحباط التي سيطرت عليه، وظهرت حتى في شكل التماثيل التي جسدت شخصيته.
وبالنسبة لأدوات التعليم التي استخدمتها الكنيسة كانت أسوأ من الفشل، لقد رفعوا بالفعل حواجز في طريق نموه الطموح الزنجي بشكله الطبيعي. كان دوما أمامه نماذج للتقليد؛ وجهوده ذاتها كانت توجه للتوافق مع شرائع التذوق المقترحة عمليًا وهو ما أضعف الهوية الزنجية، إن لم يكن دمرها، وجعل احترام الزنجي لذاته ضعيفا، وجعله ضعيفا وكأنه يزحف في بلاد المسيح. لقد كان نصيبنا منذ وقت ليس ببعيد أن نسمع الأميين الزنجي في اجتماع صلاة بنيويورك وهو يطلب من الإله أن يمد “يديه التي تشبه الزنبق الأبيض” ويبارك المصلين المنتظرين. أيضا وبشكل ثاقي آخر كان الواعظ يوحنا الثالث يتعبد بقوله “سوف أكون مثلك” رجل ذو عيون زرقاء، وخدود وردية، وشعر كستانئ “.
كان ذلك هو التصور السائد وجمع أيضا في العروض والتمايل البلاستيكية التي تشكلت كمجسد للإله. بينما الزنجي المحمدي كان لا يعرف مثل هذه التمثيلات، فالله لا يمكن تخيله في تمثال في الإسلام، وهناط قول ينسب إلى فيلسوف قديم : “حتى لو أن أنك رسمت الخيل والثيران والأسود في هيئة تماثيل يمكن أن ياتي يوم ويتحولون لآلهة على وصورهم”.
وإذا كان للثيران أو الأسود التي صنعت عن طريق الإنسان الذي عملها باستخدام إزميل أن تكون ربا، لذلك يجب أن ننظف مفهومهم عن الربوبية، وألا نتصور الخيول آلهة ولكن كخيول فقط، والثيران مثل الثيران، كل نوع إلهي له شكله وطبيعته.
بلا شك هذا الأمر صحيح فالزنجي الذي نشأ بشكل طبيعي لن يكون بالتأكيد أدنى من الأسود والخيول والثيران، لكن الزنجي المسيحي لم يتطور بشكل طبيعي، ليصور الله وجميع الكائنات الرائعة وفق صفاتهم الأخلاقية والفكرية، لكنه كان موجه لرصد الصفات الجسدية للأوروبيين، الذين كانوا يعتبرونه شرفًا حتى أنه كان بالإمكان التقريب بمزيج من دمه، حتى وإن تم ذلك بشكل غير منتظم، فهذا كان المظهر الخارجي على الأقل، وبهذه الطريقة كان يزول الشعور بكرامة الإنسان الطبيعة.
يمكن ملاحظة ذلك في أخيه الزنجي المحمدي من خلال التأثير المهم لغاية الذي أعاق الزنجي المسيحي، ويمكن إرجاع ذلك للضغوط الاجتماعي والأدبية التي عاشها الأفارقة، ولكن ليس من المبالغة القول إن الأدب الشعبي للعالم المسيحي منذ اكتشاف أمريكا، أو على الأقل منذ مائتي عام كان ضد الزنوج.
بينما لم يشعر الزنجي المحمدي بأي شيء من قوة الذبول للطبقة الاجتماعية، ولم يعاني من أي شيء بسبب لونه أو عنصره، يحرمه من أعلى الامتيازات، الاجتماعية أو السياسية، التي يمكن أن يحصل عليها أي مسلم آخر.العبد الذي يصبح محمدي كان يمكن أن يتحرر بشكل مجاني. والتاريخ المحمدي مليء بأمثلة من الزنوج البارزين. الأذان المتميز ، أو “دعوة الصلاة” ، والتي حتى يومنا هذا، تستدعي انتباه الملايين من البشر كانت شاهدة على ذلك فهي حتى يومنا هذا تحسب للزنجي بلال الحبسي بالاسم، والذي عيّن من قبل محمد، وكان هو المؤذن الأول في الإسلام.
وقد لوحظ أنه حتى الإسكندر الأكبر لم يتفاعل بهذا النظرة بل وقر الشخصية الزنجية، وهذا ما لاحظ السيد موير(مستشرق أسكتلندي) والذي رصد عدم مرونة إيمان بلال وصلابته في التمسك بالإسلام أمام واحدة من أشد المحاكمات وأقساها، ويذكر أيضا ابن خلكان في مذكرات أحد الزنوج الذي كان مقربا من الخليفة في بغداد خلال القرن التاسع الميلادي.
ويصف الجدارة التي حظي بها هذا الزنجي بين أتباع الخليفة وأنه لم يكن أحد يقدر أن يتكلم معه إلا بقدر من اللياقة والأناقة، وهناك شواهد كثيرة على ذلك والتي عبر عنها شاعر معاصر بقوله: “لا يمكن لسواد الجلد أن يحط من عبقريتك أو ينقص من قيمتك أمام العالم”.
من أمثلة ذلك أيضا الشاعر الزنجي الذي عاش في القرن العاشر الميلادي “أبو إسحاق الصابي، وكان له عبدا أسود اسمه يمنى، وكان مرتبطا به بشدة، وكتب عنه أبيات كثيرة ومميزة اقتبسها المسلمون كثيراً. والتي من بينها
قال يمني ذو البشرة الداكنة لشخص يساوي لونه بياض العين
لماذا يتفاخر وجهك ببشرته البيضاء؟
هل أنت تعتقد أنه من خلال صبغة واضحة تكتسب ميزة إضافية؟
لو كانت شامة من لوني على ذلك الوجه لتزينها؛ لكن أحد ألوانك على خدي شوهني.
الأسود يسيء لك ؛ به تزداد جمالا. الأسود هو اللون الوحيد الذي يرتديه الأمراء. لو لم تكن لي، يجب أن أشتريك ولو بكل ثروتي. ولو لم أملكك يجب أن أبذل حياتي لأحصل عليك.
يهتف ابن مسلمة، وهو عاشق متحمس في وصف معشوقته: ” قائلا الخلد الأسود في خدها القبيح يضفي عليها جمالًا ورشاقة؛ كيف يفعل مغرم القلب بالنظر إلى عشيقته أكثر؟
ومن ذلك ما ذكره المبشر الإنجليزي ويليام غيفورد بالغريف، وعلى الرغم من أن الذين سافرون في الدول الشرقية قد قللوا بلا شك من حساسية تحيزاته الغربية، إلا أنه في مقالاته الرائعة والتي يطرح فيها أسئلة عن الشرق يقف عند قصيدة كتبتها سيدة زنجية في ابنها شبه العربي المحتفى به، والذي توفي في إحدى مغامراته الجريئة.
الآن يجب أن يكون من الواضح أن الزنوج الذين تدربوا تحت تأثير مثل هذا الجو الاجتماعي والأدبي يجب أن يتمتعوا باحترام أعمق للذات، وآراء أعلى لكرامة الإنسان الطبيعي من أولئك الذين تم تدريبهم تحت التأثير القاتل للطبقية، وبتوجيه من المعيار الذي كانت سائدا لأكثر من مائتي عام والذي يظهر حتى من خلال رسم الكاريكاتير الأفريقي، والذي وظف للسخرية من خصوصياته الشخصية، وإثارة إعجابه بحس النقص الدائم واليائس.
ليس في الأدب المسيحي ما يظهره من مقارنة الزنوج المحمديين، فلا يوجد شيء في الأدب المحمدى يقابل الزنجي لا توجد كلمة الزنجي بمعناه التقليدي في الأدب المحمدي بمثل تلك الصورة، حتى في تصور رجل الدين الليبرالي كان لرسامي الكاريكاتير المسيحيين رأي أيضا. وهو ما لاحظه الباحث والمفكر الأمريكي المتميز سونيت وردزورث والذي يقول:- الرجل الأسود في الأدب إما ضعيف أو كاريكاتير. يظهر الجانب الكوميدي منه وحده. الوحيد عليها التي عليها رئيس القبيلة يأخذ بعض البريق، لكن أيضا تم تصويره في الأغاني كرمز لشراسة والانتقامية كما هو الحال في ويتير الأمريكية، وتكاد تكون خالية من التلميحات الأدبية السامية، بينما المأساوية أحد عناصر طبيعة الزنجي وحالته؛ ولا يوجد أي تخفيف حتى للصفات المضحكة.
الابتهاج والعذابات والحب وعقل الإنسان الذي لا يقهر ” لا أحد سيشترك مع الزنوج المحمديين بإعطاء أرضية للفكرة، التي تم طرحها مؤخرًا من مصدر متميز للغاية، وهي أن الإفريقي يمثل “الخارق في المنام ورمز الخوف من الرجل الأبيض”.
حتى ابن بطوطة، استشهد من قبل، رغم أنه محمدي، لم يشهد احتراما أكبر بين مسلمي نيغرولاند بسبب لونه أكثر مما يمكن أن يحصل عليه زنجي في نفس الوضع. هو يشكو من التحمل البارد والمتغطرس لبعض المبادئ الزنجية تجاه نفسه وعدد من التجار الأوروبيين والعرب الذين ظهر في حضور مخلص. ويضيف: “لقد ندمت حينها على دخول بلد الزنوج بسبب سوء سلوكهم”.
هذا الأمر حدث أيضا مع المستكشف الفرنسي Réné Caillié، الذي لم يستطيع التعامل مع الأفارقة في غرب القارة بشكل مباشر، بل لجأ إلى طرف ثالث للحديث إليهم، على الرغم من أنهم كانوا قريبين جدًا منه، وخلال رحلته التي قطعها من غرب إفريقيا إلى المغرب، عبر مدينة تمبكتو، اضطر للسفر وهو متنكر في زي مسلم فقير.
أقام Réné Caillié في تمبكتو أربعة عشر يومًا فقط، وك ان في خطر دائم من أن يتم اكتشافه، لذا وجد صعوبة من التحرك بحرية أو تدوين كل ما يرغب فيه، لذا اضطر إلى تقمص شخصية مسلم فقير، وكذلك
الوقت لتبني شخصية المسلم. وهذا التوجه تبناه أيضا السير جارنت ولسيلي، (عسكري بريطاني قاد حملات بريطانيا ضد الأشانتي) الذي كان يرى أنه من الضروري طمأنة قواته بقوله لهم: “يجب ألا ينسى جنودنا أبدًا أن العناية الإلهية قد غرست في قلب كل مواطن أفريقي خوفًا من الرجل الأبيض الذي يمنع الزنجي من الجرأة على مقابلتنا وجهاً لوجه في القتال”. 33
لكن السير غارنيت رأى أيضًا أنه من المهم إحضار الزنوج الذين ضربهم المسلحين ببنادق صوان رخيصة الثمن، وحاول إذلالهم والتفاخر بإيذائهم.
وهذه الرؤية لم تقف على حد الحرب الحديثة بل يمكن أن تجدها فيما ردد من مقولات في هذا الوقت كان الغرض الأساسي منها هو ترويج الخرافات بشأن قوة الرجل الأبيض لإخضاع الأفارقة، ولذلك كان السير ماهرا في مثل هذه الألاعيب ووظفها لخدمة أهدافه العسكرية في غرب أفريقيا.
وهل هي غش أم فضيلة فمن يطلبها في العدو؟
ومع ذلك أكد لنا ما حدث في مدينة أكولاند (مدينة بنيوزيلندا) أن موجة النقد هذه لم تكن صحيحة، وأن البيض تفوقوا ليس لأنهم أكثر شجاعة من الزنوج ، والدليل أنهم لم يستطيعوا شق طريق إلى مدينة كوماسي (مدينة في غانا) رغم امتلاكهم الأسلحة الدقيقة، والبنادق والصواريخ، بالإضافة إلى مهارة اللغة الإنجليزية والانضباط.
ولو أن السير جارنت، حتى قبل خبرته العملية، قرأ تاريخ الحرب الأهلية العظيمة في أمريكا، لكان قد رصد حالة الرعب التي رصدتها السجلات العديدة للمواجهات، والتي أثبت فيها الزنجي أنه ليس خصمًا جبانا عندما التقى بالرجل الأبيض “وجهًا لوجه في القتال”.
ولولا محاولات الغزاة البيض لفرض رقابة على تلك الحماسة عبر ترويج الخرافات حول الرجل الأبيض لما استطاع Weadmit أن يكتسح الزنجي في الأراضي المسيحية، وعلى طول الساحل حيث كان تحت تدريب الرجل الأبيض، لكن ما حدث من تراجع الزنوج أمام البيض كان له أسبابه بل كان نتيجة طبيعية لتلك العادة الذهنية التي كان من مصلحة أسياده إقناعها به. ظهر ذلك في ممارسات السيد جارنت، وهي واحدة فقط من الممارسات التي لا تعد ولا تحصى مما مورس على الزنجي، والتي كن الهدف منها أن يبقى الزنجي باستمرار في تشربها، حتى أنها روجت من قبل المرشدين الدينيين في كثير من الأحيان، وهذه النزعة كان الغرض الرئيسي منها هي إضعاف الزنجي وإضعاف إحساسه الطبيعي بكرامته البشرية.
عنصر آخر مهم للغاية أعطى المحمدية ميزة على المسيحية في أفريقيا وهو التعاطف الذي كان موجودًا دائمًا بين الزنجي وبين معلمه العربي، وعن ذلك يقول السيد بوسورث سميث: – يُظهر المبشرون المسلمون الصبر والتعاطف والاحترام للعادات والأحكام المسبقة، وحتى لعاداتهم غير المؤذية المتعلقة بالمعتقدات، والتي هي بلا شك أحد أسباب نجاحهم، والتي من الأفضل أن يقلدها المبشرون ومعلمونا. 35
قبل ظهور الإسلام بوقت طويل، كما ذكرنا أعلاه ، كان التاجر العربي على اتصال مع المناطق الداخلية لأفريقيا، فتح هذا الطريق أمام المبشر العربي. لذلك عندما كان جاء التبشير الإسلامي ليروج لدين جديد أعلى من أي دين آخر كان معروفا لأبناء غرب أفريقيا ولم يدخل البلاد كغريب، بل كرجل تمت بالفعل تجربة، وما أن دخل حتى بدء في تدشين المؤسسات السياسية والاجتماعية المناسبة لاحتياجات وأذواق القبائل الزنوج.
وفي الواقع فإن الشعبين لم يكن بينهما اختلافات كثيرة بحكم أن لديهم تواصل طويل الأمد حتى على المستوى الشعبي، كما أن هناك تشابه في التأثيرات الجسدية وكذلك في بعض العادات وهو ما جعل الأذواق متشابهة؛ ولذلك لم يكن صعبًا أن يتكيف العرب مع نسبة كبيرة من العادات الاجتماعية والمحلية للأفارقة، وكثيرا ما أستحضر المبشر المسلم تأثير العلاقات الاجتماعية والمحلية في عملية الوعظ – وهو تأثير لا يتم تجاهله تمامًا في محاولات تحوّل الناس إلى الإسلام، فكما كان يقول ستانلي إن “تحويل الأمة الروسية” لم يتأثر بوعظ الدين البيزنطي، ولكن تم من خلال زواج أميرة بيزنطية “. 36 لذلك غالبًا ما دخل المبشرون العرب في روابط زواج مع بنات نيغرو لاند، ولم يقف الأمر على حد تزاوجهم مع السكان الأصليين، بل من خلال التجارة التقليدية وكرم التجار العرب، فقد جندوا العديد من المصالح ومثل هذه التعاطف العميق لخدمة أفكارهم، والتي سرعان ما رسخت جذورها في البلاد.
وذخرت السُنة بمواقف كان العربي والزنجي فيها جنبا إلى جنب، وهذا لم يقتصر على الأدب الإسلامي كما تقدم، ولكن ما قبل الإسلام أيضا، نشأ من أحفاد العرب والأفارقة معا وذخرت بهم الحكايات الشعبية.
لذلك فإن الارتياح بين المبشر العربي والأفريقي كان أكثر من التعاطف بين الأوروبي والزنجي، وليس العكس، كما أنه نادرا ما يتخطى ما يتخطى الأوروبيون الشعور بالفوقية، إن لم يكن بالنفور عند مشاهدة الأفريقي للمرة الأولى، بينما العربي كان يعترف بفرح أن الزنجي هو أخوه، وله نفس الطبيعة في الجوهر
والصفات، ومع ذلك نظرًا للتنوع في النوع واللون، فإنه يستنتج بشكل طبيعي أن الدونية التي تظهر له على السطح يجب أن تمتد أعمق من الجلد وتؤثر على النفس. لذلك في كثير من كان الأفريقي يتوق إلى الهرب ويرفض تحوله، حتى عندما يتم تدريبه من قبل الأوروبيين كان المدرب يشعر بأن لديه الكثير من التقدم في الحضارة والقلوب. وعلى وجه الخصوص هذا هو الحال في غرب إفريقيا، حيث يعيش بين جماهير كبيرة من مواطنيه الأفارقة المسيحيين الذين تم إجبارهم على تشرب التقاليد الأوروبية، وكان الإفريقي يقدم في كثير من الأحيان للمراقب الأجنبي مظهرًا مصطنعًا وعبثيًا. بينما المبشر ينظر من مسافة اجتماعية مريحة، وهذا ما نراه في استطلاعات الرأي للمواطن الأوروبي، الذي ينظر للإفريقي أحيانًا بشفقة، أحيانًا بفزع، ونادرًا ما يكون دقيقًا.
أو على غرار ما يحلم به جان راسين (شاعر فرنسي) عند رؤية الوحش الذي غسله على الشاطئ: -“التيار الذي جلبه يرتد في رعب” كذلك كان تحول الأفريقي في ظل هذا التعليم العملي، ينظر إلى معلميه المتفوقين على نفسه – أو على الأقل بعيدًا عن نفسه، ليس فقط في المعرفة الروحية والزمنية، ولكن في كل النواحي الأخرى – يكتسب رأيًا منخفضًا جدًا عن نفسه، ويتعلم أن ينتقص من قيمته خصائصه الشخصية، ويفقد ذلك “الإحساس بكرامة الطبيعة البشرية” وهو على عكس الذي لاحظه الرحالة في المحمدي زنجي.
وفي المقابل كان المبشر العربي في كثير من الأحيان، مثل سامعه ، لا “يتطلب أشياء كثيرة للتصالح معه لذلك عاش في نيغرو لاند مدى الحياة، واختلط دمه بدم السكان، ونجح في ترشيخ الدين المحمدي بأكثر الأشياء طبيعية، وعلم الناس الدين الجديد ببساطة وبدون أن يستخدم أي جهاز ، مثل سريره المحمول ومخطوطاته الزائفة، قد يكون أدنى من العالم اللاهوتي والكلاسيكي حديث العهد في أوروبا أو أمريكا ، ولكن لديه ميزة التحدث إلى الناس بلغة غير متعاطفة ومفهومة تمامًا.
سنختم باستخراج آخر من عند السيد. بوسورث سميث والذي يقول فيه:- إن المحمدية، عند إزالة سوء التفاهم المتبادل، يمكن رفعها وتوبيخها وتنقيتها بالتأثيرات المسيحية، وكذلك المسيحية الت تمثل الروح عكرتها عمليات من الشرور مثل تجارة الرقيق، التي هي في الحقيقة غريبة عن طبيعتها، لكن يمكن إخمادها من خلال الجهود البطولية للمحسنين المسيحيين، وبالتالي يمكنني أن أتطلع بشيء من القلق، وبمزيد من الأمل إلى ما مصير إفريقيا، ستندثر الوثنية وعبادة الشيطان، وسيصبح الجزء الرئيسي من القارة، إذا لم يصبح مسيحيًا فمن الأفضل أن يكون محمديا.
كانت غرب إفريقيا على اتصال بالمسيحية منذ ثلاثمائة عام ، ولم تصبح قبيلة واحدة مسيحية بعد. ولا يوجد أي إنجازات مؤثرة تبناها الدين الذي جلبه المبشر الأوروبي. من جامبيا حتى الجابون، المواطنون لا زالوا يتفاعلون بشكل ثابت وتقليديو ويعيشون نفسه حياتهم القديمة ويمارسون عاداتهم وتقاليدهم القديمة في محيط المستوطنات المسيحية، حيث لم يتم تغيير أو تعديل العادات من قبل نفوذ المحمدان. الذي وصل لأوجه في السابق، بل ظلت سيراليون شبه محمدية. لكننا لا نعتقد أن هذه القبائل يتعذر الوصول إليها بشكل يائس لتأثير دين الإنجيل. نحن نعتقد أن “عندما يتم إزالة سوء الفهم بشكل متبادل يمكن العلاج بشكل أفضل؛ عندما يتوقف الجهد الأوروبي العشوائي؛ عندما يكون التشير عقلاني وأن يعرف المبشر أو يتعلم : “الحياكة الذاتية للناس هي هدية مقدسة، تُمنح من أجل بعض الأغراض الإلهية، لتعتز بها وتكشف بصبر”.
وفي هذه الحالة لن يكون هناك ما يمنع المسيحية من الانتشار بين القبائل الوثنية، ومن اقتلاع المحمدية غير المثالية التي تسود على نطاق واسع. في غضون ذلك، لا ينبغي لنا منح الأفارقة لمحات من الحقيقة التي يلتقطونها من القرآن، لأن “معرفة جزء أفضل من الجهل بالكلية.” 43
ويبدو أن القلق اللاسيء يسود في أوساط معينة من سيادة النفوذ المحمدي في أوساط معينة وخاصة في أفريقيا، من خلال السعي لإظهار أنه حيثما يسود، فإنه يشكل حاجزًا لا يمكن التغلب عليه أمام تقدمنا الإضافي – أنه ينتج ما هو أكبر من الحركة الصينية.
ظهر ذلك في مقالا كتبه مؤلف إنجليزي عن المحمدية ونشر في يناير 1872، والذي يقول فيه إن “الإسلام هو الإصلاح الذي خنق كل الإصلاحات الأخرى، إنه إصلاح قيد كل أمة قبلته في مرحلة معينة من النمو الأخلاقي والسياسي”.
ومن هذا أيضا ما كتبه فريمان في بيانه الشهير والذي يقول فيه إن تاريخ العرب وفتوحاتهم كرست تعدد الزوجات، والعبودية، وتبعية من هم غير عرب لهم، وأنهم فعلوا ذلك من منطلق دينيا إصلاحيا”. وهاذ ما يمكن أن يرد عليه من قبل أي كاتب مسلم بأن يأخذ هو الآخر نظرة سطحية لتأثيرات المسيحية، وقد يقول “المسيحية قد كرست السكر؛ كرست عبودية الزنوج. وقد كرّست الحرب “وقد يجمع مجموعة من المواد التي تؤكد ذلك من تاريخ المسيحية خلال الثلاثمائة سنة الماضية، وخاصة في نصف الكرة الغربي.
وهنا نتساءل هل يجب أن تتعرض المحمدية لهجوم شرس لأنها خلال مائة عام من الوجود لم تنهي الشرور من الدول التي تسود فيها؟ يجب ألا نؤيد ذلك لأنه ينطبق على المذاهب الأخرى كما هو الحال مع الإسلام، لأن لاهوته كان تابعا للمصالح الدنيوية؟ قد لا نعتقد أن العديد من الشرور في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الإسلام، لم ينته منها الشرور ليس لأن تعاليم عجزت عن ذلك، ولكن لأن الإنسان فعل ذلك. أو كما قال السيد. ماكلير ، “الكنيسة في أوروبا كانت منخرطة في القضاء على ما تبقى من الوثنية، واحتجت على ممارسات الوثنية الوقحة وعبادة الأفاعي”.
يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أقوال مثل تلك المشار إليها أعلاه يستمر البعض في ترديدها لأغراض شخصية أو أدبية، وهم بذلك يميلون إلى إدامة شعور الكنيسة المسيحية بعدم الثقة في أي جهد للتبشير، لأنه لن يضاهي ما فعله الإسلام، لكنهم يفشلون في إضعاف “نجاحات الرسول محمد التي تحققت في أفريقيا”.
الأكثر من ذلك أن حملات التبشير المسيحية دائما ما حاولت ترديد الاتهامات نحو الإسلام حينما تتكلم عن سلبيات أفريقيا، معتمدين على الكتابات التي تمت في العصور الوسطى، كما أوضح السيد بوسورث سميث، لكن حاليا باتت الحقائق واضحة، بما يتناسب مع نمو معارف أكثر دقة، وباتت واضحا أن هذه الإدانات كانت متعمدة، وخصوصا أن بلاد أخرى في أفريقيا وغيرها كانت مهدا للإسلام وانطلق منها نحو العالم.
كما أن الإسلام جاء على يد رجل من نسل إسماعيل المعروف في تاريخ السامية، أي أنه جاء نسل متسامح وليس من نسل عنيف، كما أن المحمديون الأفارقة لم يكن كغيرهم، مثل ما فعل الفرس مثلا، بل لوحظ تسامحا هائلا من قبل المسلمين حتى أنهم لا يمانعون وجود مدارس مسيحية في بلادهم، ولا حتى يعارضون تداول الكتب المقدسة المسيحية فيما بينها في المدن.
في ضوء العمل الذي أنجزه الإسلام بالفعل لأفريقيا والزنوج، والعمل الذي قد ينجزه بعد، يمكننا أن نقول ما كان يعتقده موهلر (عالم نفس بريطاني) والذي نقلته صحيفة الغارديان حيث كان يقول: “يومًا ما قد يجد المتشائمون (في إفريقيا) محصولًا جاهزًا يحصدونه، ويسرع الإنجيل إلى هناك في طريقه مبتهج، ويصبح محمد يخدم المسيح”.
التعليق على أفكار إدوارد بلايدن الواردة في الفصل الأول
من خلال التعرض لبعض من أفكار بلاين في كتابه المعنون بـ”Christianity, Islam and the Negro Race/المسيحية والإسلام والعرق الزنجي” وتحديدا الفصل الأول من كتابه الذي نحن بصدده يمكنا القول إن بلايدن لم كان نظرة تحليلية عميقة وشمولية بخصوص تفاعل الأفارقة وتحديدا في غرب القارة مع الأديان التي وردت على هذه المنطقة، مقدما ملمحا تاريخيا عن تاريخ الإسلام والمسيحية في أفريقيا، وأيهما كان مناسب أكثر لسكان هذه المنطقة.
في هذه المقارنة لا يقارن بلايدن بين الإسلام والمسيحية في أفريقيا من منطلق ديني لاهوتي، رغ أنه كان في بداية حياته مرتبطا بشكل كبير بالكنيسة وتلقى تعليما لاهوتيا، ولكن يقارن بين المحمدية كما يسميها والمسيحية من خلال تفاعل أصحاب كل دين مع الأفارقة، واستقبال سكان غرب أفريقيا لتعاليم الدين الجديد.
في كتاباته نجد أنه اعتمد بشكل موضوعي على آلية دخول الإسلام لغرب أفريقيا وأنه لم ينتشر هناك على يد أجانب بل على يد أفارقة من الشمال وسرعان ما نجح في تجنيد الزنوج أنفسهم لنشر تعاليمه بين السكان، كما أنه يركز على التفاعلات الاجتماعية بين المسلمين الأوائل في المنطقة وبين أهل المنطقة من خلال التجارة والزواج وعلاقات الجيرة التي اتسمت بالإنسانية ولم يجد فيها الإفريقي أي تعال أو نفور من قبل المبشر المسلم، على عكس ما حدث من قبل مبشري الكنيسة الذين جاءوا من أوروبا.
ليس هذا فحسب بل إنه يستدعي مواقف من الإسلام الأول في الجزيرة العربية وموقع الزنوج داخل منظومته ويستشهد بالاحترام الذي حظى به بلال بن رباح الحبشي، رغم أنه كانا عبدا وبشرته سوداء لكن الإسلام رفعه بشكل متساوى مع النخبة العربية وقتها، كذا يستدعى مواقف من الشعر العباسي وكيف احتل الزنوج موقعا مميزا حتى العبيد منهم حظوا بعلاقة جيدة مع مواليهم، بعكس الزنجي الإفريقي الذي حوله السيد الأبيض إلى مهرج أو خادم ولعب بهد مثلما يلعب بالقردة.
يركز بلايدن على نقطة جوهرية في علاقة المسلم بالإفريقي مقارنة بالمسيحي الأبيض، فالأخير جاء ناقما على العادات والتقاليد الإفريقية وحاول تغييرها بالقوة وربط العطايا التي توزعها الكنيسة بمدى التخلي عن تلك العادات، بينما الإسلام الذي دخل أفريقيا قبل المسيحية بألف سنة تعامل باحترام مع العادات والتقاليد الإفريقية واحترمها وقاوم العادات والتقاليد الشريرة فقط، بل بالعكس كان يتم تعليم الأفارقة من قبل المعلمين المسلمين بشكل يسوده الاحترام.
الأمر الأخير يركز بلايدن أيضا على نقطة تعلق الأفارقة بالإسلام وإجبارهم لأبنائهم الصغار على حفظ القرآن وقراءته من الذاكرة بشكل لم يحدث مع أي دين آخر، ولذلك كان يرى أن الإسلام هو الدين المناسب للأفارقة لأنه احترمهم منذ اليوم الأول، وهو دين الأباء الحقيقي، وليس ما جاء به السيد الأوروبي.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب





